بديع الزمان مسعود
الصورة: (سوهارتو يلقي خطاب استقالته - صور نشرتها الحكومة الإندونيسية وأتاحتها للتداول العام)
على امتداد عشر سنوات من عمر النزاع في سوريا، صدرت قرارات دولية عديدة، بعضها شكل أرضية لعدد من المسارات الحوارية التي يكاد ينحصر الرهان فيها للانتقال إلى حكم ديمقراطي يمهد لمستقبل مغاير.
في هذا السياق، تحضر التجربة الإندونيسية التي جرت مقاربتها ضمن «نظرية المباراة» الشهيرة (Game Theory).
تُعرّف المباراة بأنها موقف (أو أكثر)، يتولى فيه لاعبان (أو أكثر، تبعاً لعدد القوى السياسية المتباينة ذات الأهداف المتعارضة) الاختيار العقلاني بين استراتيجيات بديلة عن الوضع القائم، وتعتمد فيها الأطراف سلسلة قرارات تنتج منها، كما يُفترض، منافع لها ولأنصارها (أهداف ونقاط)، قد تكون ملموسة مثل المنافع الاقتصادية، أو غير ملموسة كالقيم والسلطة والنفوذ (نظرية المباريات ـ حامد هاشم ـ مكتبة مدبولي ـ 1984).
قد يكون التعريف الأكثر بساطةً وواقعيةً للانتقال الديمقراطي أنه «مجموعة عمليات متدرجة للوصول إلى حلول للمشكلات التي يعيشها بلد ما، بعدما وصل إلى طريق مسدود في الفضاء السياسي أو غيره، متضمنة المسألة الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة والأحزاب والعسكر والمجتمع عموماً».
وسط ذلك تتسم عمليات الانتقال الديمقراطي بقدر كبير من الشك في ما يتّصل بمستقبلها، خاصة نسبية قبولها من الأطراف الفاعلة، لأن هناك جملة من العوامل التي تتدخل وتتداخل في صياغة وتشكيل العملية من داخلها ومن خارجها وصولاً إلى آليات تنفيذها المحتملة.
تحصر غالبية أدبيات التحول الديمقراطي أمام النظم السلطوية خياراتها في اتجاهين استراتيجيين هما: القمع، ومن ثم التمسك بالسلطة، أو الخضوع والقبول بمطالب المعارضة الداعية إلى تبني إصلاحات ديمقراطية تتيح للمعارضة لعب دور ضمن هيكل الحياة السياسية للدولة والمجتمع.
يزداد احتمال القمع إذا كانت المعارضة غير قوية بدرجة كافية، ثم يبقى النظام، مثلما الحال في سوريا. أما إذا كانت المعارضة قوية، فتزداد تكلفة القمع، ويصبح خيار الديمقراطية أفضل من خيار الاحتفاظ بالسلطة، ولكن الأخير ليس خيار الأنظمة، خصوصاً في ظل وجود عوامل موضوعية وذاتية تلعب دوراً في تقرير اتجاه اللعب في ساحة هذه البلاد أو تلك.
ثمة «طريق ثالث» اختبرته بعض حالات الانتقال الديمقراطي حول العالم، وسطٌ بين فوز أحد الطرفين وخسارة الطرف الآخر، ويقوم على قبول الأطراف كافة بإقامة ديمقراطية تحدّ من سيطرة النظام/الحكم، وتأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف المقابلة من معارضة وقوى أخرى، من ضمنها مصالح القوى الدولية والإقليمية. تعد هذه العملية من أصعب العمليات السياسية وأطولها وأعقدها في التخطيط والتنفيذ، وتبدو كأنها سير في حقول ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة.
يراعي هذا الانتقال الديمقراطي النظامَ القديم والفئات والطبقات المرتبطة به. ويرتبط التحول في هذه الحالات بقيود دستورية تحد من قوة الغالبية. وتجبر من يتولى السلطة لا على مراعاة مصالح النخبة السلطوية المسيطرة قبل عملية التحول وخلالها فحسب، بل والجماعات المرتبطة بها أيضاً، وتحمي في الوقت نفسه مصالح الأطراف الأخرى من خطر تغوّل النظام/الحكم، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع في صنع القرار الوطني وفي شكل الدولة والهوية والحوكمة، وغير ذلك من أساسيات.
في سياق نظرية المباريات وعلاقتها بعملية الانتقال الديمقراطي، تظهر أهمية عملية التصميم الدستوري أو الهندسة الدستورية، التي تحدد ملامح الصفقة الدستورية الموجّهة لمسار التحول الديمقراطي الجديد بين الأطراف الفاعلة. يقصد بالتصميم أو الهندسة الدستورية «عملية بناء الدستور». وهذه الأخيرة تنطلق من «اللحظة الدستورية»، أي «لحظة التوازن المطلوب لترجمة القيم السياسية والحقوقية التي يفترض الجميع أنّ من الأفضل أن تسود، وأن تنص عليها كتابةً» (عزمي بشارة، أطروحات حول اللحظة الدستورية).
وفق المنطق العقلي والسياسي، تفترض الهندسة الدستورية (أو اللحظة الدستورية) إيمان كل طرف بأنه سيكون في موضع أفضل إذا بقي قريباً من الطرف الآخر، بمعنى التوقف عن التمترس وراء طروحاته الخاصة والبحث عن منطقة مشتركة في اللعبة (وسط الملعب)، والأهم بغاية الاقتراب من الدمقرطة التزام الترتيبات المؤسسية الجديدة التي تفضي إلى انسحاب النظام السياسي من بعض المساحات وترك المجال للتغييرات الجديدة، أو اقتراب المعارضة من نظم الحكم وآلياتها وإدراك الدولة من داخلها.
مُحركات الانتقال الديمقراطي في إندونيسيا
كان المحرّك الرئيس لعملية الانتقال الديمقراطي في إندونيسيا هو العامل الخارجي، ففي صيف 1997، كان سوهارتو وإندونيسيا غارقين في أخطر تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية واجهتها البلاد منذ منتصف الستينيات، في ظل الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في تايلاند المجاورة منذ تموز/يوليو 1997، وانزلقت الروبية الإندونيسية من سعر واحد دولار أميركي مقابل 2400 روبية منتصف 1997 إلى أكثر من 17500 في آذار/مارس 1998، بعد ترشيح بحر الدين يوسف حبيبي لمنصب نائب الرئيس سوهارتو.
لم يغرق الجيش الإندونيسي في دوامة عنف لا نهائية ضد المحتجين، ولم يفكر هؤلاء بمعاداة الجيش، كما استثمروا المسار الانتقالي في تحقيق مزيد من الاختراقات نحو الديمقراطية
آنذاك، كانت إندونيسيا الأكثر تضرراً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بين البلدان الآسيوية التي تضررت من الأزمة، إذ ارتفعت نسبة البطالة، وأفلست عشرات الشركات وهربت رؤوس الأموال، وتبنّى الرئيس سوهارتو سياسات اقتصادية لاقت رفضاً شعبياً واسعاً.
العامل الخارجي هنا تمثّل في صندوق النقد الدولي الذي قدّم «خطة إنقاذ» رحّب بها نظام سوهارتو لإنقاذ إندونيسيا ووصفت وقتها بالقرار الحكيم، وقد هدفت إلى استقرار الروبية عند 3000 روبية مقابل كل دولار أميركي، وتم التفاوض بشأنها مع الصندوق.
غير أنّ الخطة جاءت بنتائج عكسية، وفشلت في تحقيق التأثير المطلوب وساهمت في زيادة مشكلات البلاد الاقتصادية (حتى اليوم) عبر توجيه الانتباه بعيداً عن المشكلات الحقيقية والتركيز على القضايا الثانوية نسبياً. بعد ستة أسابيع من إبرام الحزمة، تراجعت الروبية للمرة الثانية، إذ انخفضت من 4000 للدولار إلى 12000 بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأوائل كانون الثاني/يناير 1998، ثم جرى التفاوض على حزمة إصلاح ثانية في 1/1998 لم تستطع وقف الانزلاق.
وسط ذلك، اندلعت احتجاجات وأعمال شغب واسعة في البلاد وصلت إلى المدارس والجامعات، وتصاعد في الوقت نفسه تيار في حركة الإصلاح التي شكّلت نوعاً من المعارضة المدنية الهادئة طوال سنوات التسعينات، يطالب بتعامل الحكومة مع الاحتجاجات معترفةً بمطالبها وأن توقف عن قمعها الذي بدأ به الجيش.
تُمكن - بحذر شديد - مقارنة مرحلة احتجاجات إندونيسيا هذه باحتجاجات سوريا ربيع 2011، مع الانتباه إلى أنّ المطالب الاقتصادية لم تكن حاضرة علناً في الاحتجاجات السورية.
ومثلما تطورت الاحتجاجات السورية إلى المطالبة بـ «إسقاط النظام»، تطورت الاحتجاجات في إندونيسيا نحو المطالبة باستقالة سوهارتو ونهاية «الوظيفة المزدوجة للجيش»، وتأسيس نظام ديمقراطي سليم. كلّ هذه المطالبات كانت لتبقى مجرّد حبر على ورق في انتظار موقف الجيش الإندونيسي لحسم المسألة، أي بقاء سوهارتو في الحكم لولاية سابعة، إذ لم يكن قد مضى على تجديد ولايته عشرة أيام حين اندلعت الأزمة المالية الآسيوية.
كان موقف الجيش مفصلياً، فقد رفضت غالبيته الدخول في حلقة عنف متتابعة ضد المحتجين، وإغراق البلاد في دوامة عنف دموية لا تُعرف نهايتها مثلما حدث في سوريا. عند هذه النقطة ثمة تحليلات عدة في تفسير موقف الجيش، منها، كما يذهب مؤلف كتاب «أمة في الانتظار» Adam Schwarz أنّ الجيش لم يكن مستعداً للتورط على نطاق واسع في مساندة رئيس فقد شعبيته بعد مدة حكم طويلة، خاصةً أن سوهارتو فقد مع الأزمة الاقتصادية أساساً مهماً لشعبيته، ألا وهو الإنجاز الاقتصادي.
هناك رؤية ثانية قد يكون لها شبيه في منطقتنا، تقول إنّ الجيش الإندونيسي المدعوم أميركياً كان يرغب في التخلص من الرجل العجوز والإتيان بوجوه جديدة أكثر قوة وارتباطاً به، ومن هنا كان اختيار الجيش نائبه لمرحلة انتقالية نحو البحث عن شخصية أكثر قوة وحضوراً عسكرياً، وتذكر هذه الحالة بالحالة المصرية غداة الربيع العربي.
رأى آخرون أن سوهارتو نفسه كان «ضحية» إنجازاته الاقتصادية التي أتاحت مزيداً من فرص التعليم أمام جيل شاب لم يقبل استبعاده من المجال السياسي، وبشيء من المقارنة، نجد أنّ هذا الرأي قد ينطبق جزئياً على الحالة السورية، فالفضاء السياسي السوري كان ولا يزال حكراً على بنية سلطوية صادرت الأجيال الجديدة وحضورها السياسي ودورها.
احتل الطلاب مطلع آذار/مارس 1998 البرلمان الإندونيسي ثلاثة أيام، واندلعت أعمال شغب. وفي اليوم التالي، دعا قادة المجلس التشريعي عدداً من قادة حركة الإصلاح للنقاش العام. ثمّ صوت حزب جولكار/ Golkar، الذراع السياسية لنظام سوهارتو وصاحب الغالبية في البرلمان، على طلب استقالة الرئيس بأغلبية 160 مقابل 125. أدى ذلك، إلى إعلان الأخير استقالته في 21/5/1998، منهياً بذلك حكماً استمر 23 عاماً، ليتولى السلطة نائبه بحر الدين يوسف حبيبي.
أدّت هذه التطورات إلى فرض القوى الاجتماعية والسياسية التي ترعرعت في ظل نظام سوهارتو، نفسها على المرحلة الانتقالية، واستحواذها على المؤسسات الديمقراطية الرسمية خلال الانتقال وبعده، وفرضت مصالحها على المستويات كافة.
قد يفسر وضعها هذا عدم انقلابها على المسار الانتقالي مثلما حدث في اتجاه السلطة إلى القمع في سوريا، إذ إنّ التفكير القطعي للمعارضة في إقصاء كامل مكوّنات النظام السياسية والاجتماعية والاقتصادية من سدّة الحكم في سوريا، كان أحد أسباب الدفع نحو أزمة وطنية انفجرت في شكل عنف غير مضبوط لاحقاً. هذا من دون أن ننسى أنّ المعارضة في سوريا قد تعرضت إلى ضغوط هائلة أفضت إلى «غربلتها»، بحيث تتصدر المشهد تشكيلات يمكن ضبطها على إيقاع القوى الخارجية الداعمة، في حين مارست السلطة السورية تعنتاً تاريخياً في رفض تقديم أي تنازلات حقيقية.
لم يفكر المحتجون في إندونيسيا بالانقلاب على الجيش ومراكز قواه المتجذّرة في بنيان الدولة، وذلك بالنظر إلى عناصر القوة التي يمتلكها عسكرياً واقتصادياً وتاريخياً، وبحكم الوظيفة المزدوجة التي اضطلع بها طوال مرحلة ما قبل استقالة سوهارتو، عدا عن وجود أنصار مؤكدين للنظام من الجمهور. في الوقت نفسه، فشلت الاحتجاجات في تحقيق انتصار حاسم على النظام، ولكنها أضافت عنصر توازن جديداً بين السلطة والمعارضة الأقدم لمصلحة الأخيرة.
يتبع
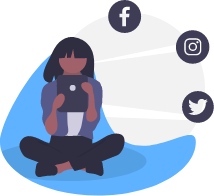
لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

