بديع الزمان مسعود
الصورة: (Benedikt Saxler - فليكر)
منذ تطورت البشرية واتخذت لنفسها نظماً في المُلكية مبنية على الطمع بالدرجة اﻷولى، ارتفع وعلا جدل الحق في الملكية، وكلما ذهبت البشرية حدوداً أبعد في صراعاتها، وانتقلت من الحيز الفردي إلى القبلي ثم المديني ثم الدولة، ازدادت الحاجة إلى ضبط العنف، وقوننته، وتسليمه إلى جهات أو مؤسسات أو منظومات تتولى إدارته بنوع من العقلانية.
لم يكن الفرنسي جان جاك روسو أول فيلسوف في التاريخ تحدّث عن الرابطة بين الشعب / الرعية، والدولة، أو السلطة، أو الهيئات، التي تمتلك صلاحيات استخدام العنف المقونن في المجتمع الإنساني، وفق ما اصطلح على تسميته «العقد الاجتماعي».
لكنّ روسو، في كتابه الشهير «في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي» المنشور في العام 1762 (قبل أكثر من قرنين ونصف القرن) دفع بهذا الجدل مسافةً متقدمة.
كان ابن خلدون، أحد الذين تناولوا أيضاً المسألة ذاتها، أي علاقة الفرد بالسلطة، فذهب باختصار إلى أنّ تنظيم الحياة الاجتماعية وتصريف أمور المُلك يتطلّب الرجوع إلى «قوانين سياسية مفروضة يسلم بها الكافّة (أي الجميع) وينقادون إلى إحكامها»، و«إذا كان المُلك قاهراً باطشاً منقّباً عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل، وربّما خذلوه في مواطن الحروب».
تنبع أهمية العقد الاجتماعي من أنّه ينظّم العلاقة الرابطة بين الفرد والمجتمع، والفرد والدولة، على قاعدة بسيطة هي قاعدة الحقوق والواجبات التي يختصرها الفقه الإسلامي بعبارة بليغة موجزة «لا ضرر ولا ضرار». وإذ تختلف الرؤى بين الفقهاء والفلاسفة في سلّم أولويات هذا العقد، لناحية الضرر والإفادة والحق والواجب، فإنّ اﻹطار العام لهذه الأولويات يبقى نفسه.
من زاوية عربية
في كثير من البقاع خارج العالم العربي، لا يمكن أن نرى من يقبل «الخضوع» للسلطة مقابل اللاشيء حرفياً: لا حقوقاً سياسية ولا اجتماعية ولا حريات عامة ولا شخصية. في المقابل هناك سلطة مطلقة للحاكم وأجهزته «تقود» المواطن حيث تريد، في محاولة لتطويع شعب يتحكم به الخوف والقمع والحاجة.
هذا الكلام ليس جلداً للذات بأي طريقة، لكنه تبيان لحقيقة واضحة تُمارس منذ عقود على امتداد أوطاننا المثقلة بأحمال كثيرة لا تتيح للناس اﻹبداع، والخروج من دوامة الحاجة.
الأمر من جانب آخر ليس مجرد «قلق ثقافي»، بقدر ما هو سؤال معرفي يطرح نفسه في الواقع العربي الذي يتهاوى فعلاً نحو الدرك اﻷسفل من المحيط إلى الخليج.
بعد انطلاق قطار «الربيع العربي» (أو أياً تكن التسمية التي التي يفضّلها القارئ/ـة) انكشفت الحاجة الماسّة إلى إعادة النظر في صيغ العقود الاجتماعية العربية، فكفة الحقوق والواجبات مائلة كثيراً لجهة الدولة، سواء كان سبب الميلان غياب الحقوق السياسية أو الاقتصادية وندرتها في هذه المنطقة، أو كان التغوّل السلطوي الناجم عن بنى فساد تأصّلت في قلب اﻷنظمة.
يرى ابن خلدون أن تصريف أمور المُلك يتطلّب قوانين سياسية مفروضة يسلم بها الجميع، فـ«إذا كان المُلك قاهراً باطشاً منقّباً عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل، وربّما خذلوه في مواطن الحروب»
إعادة النظر في العقود الاجتماعية ليست عملية يسهل القيام بها بين عشية وضحاها، فوفقاً لقوانين المجتمع الفيزيائية هناك صراعات متعددة بين طبقات اجتماعية متحركة لا تتلاقى مصالحها ضمن منظومة الدولة الراهنة، وبين قوى يُزعم أنها قوى سياسية معبّرة عن مصالح الجماهير نفسها، وبين قوى أخرى تريد أن تحل محل السلطة في إدارة الدولة والمجتمع. هذه الصراعات في العالم العربي غالباً ما كانت محصّلتها أقرب إلى الصفر، وفي سوريا تجلّى ذلك عبر انفتاح «علبة الشرور السورية» على الجميع، مؤدّيةً إلى ضياع (شبه) كامل لمفاهيم الدولة والمواطنة والسياسة والقانون، ووضع البلاد أمام مشهد جديد غير مستقر، أنتج نمطه الخاص من «العقد الاجتماعي» غير المبني على قاعدة صلبة، تغيب عنه صورة الواقع بما هو مستندٌ أصلي لبناء القانون، كما تغيب عنه صورة المثالي بما هو مشتهى للاتجاه صوب «دولة الحق والواجب» بتعبير روسو نفسه.
الهوية الوطنية وأساسياتها
للعقد الاجتماعي دور محوري في تشكيل الهوية الوطنية (أو الـ تحت / فوق وطنية).
لتبسيط المسألة، ومن دون الخوض كثيراً في التفاصيل، هناك مثالان دالّان: الأول ما تتركه العقود الاجتماعية المفروضة في مناطق سيطرة الجماعات «الجهادية» من تأثير على الهوية، وربط لها بفكرة «الجهاد الكوني»، والثاني ما يحدثه ارتباط جزء وازن من سكان سوريا بدولة أخرى هي تركيا، ونعني هنا ارتباطاً يومياً معاشاً بكل ما يتصل بالحياة: من عملة، وخدمات، وتعليم... إلخ.
كان زكي اﻷرسوزي الذي تأثر بالمدرسة الفرنسية في فلسفة الدولة واﻷمة، قد اعتبر أن أهم محددات اﻷمة هي «اللغة، والدين، والثقافة، والأرض، والتنظيم الاجتماعي». هذه المحددات في الحالات القطرية العربية هي ذاتها محددات الهوية الوطنية.
ومن دون الدخول كثيراً في جدل هذه العوامل، فإنّ مسألة اللغة تعتبر مجازاً أساسياً وحقيقياً للهوية الوطنية، إذ تحظى بأهمية كبرى تتضح في الضياع العربي الحالي بين العامية والفصحى، وبين اعتماد العربية لغة وطنية وحيدة، واعتماد لغات أخرى كما كان يجب في الحالة السورية، بالنسبة للكردية والسريانية وغيرها. وكثير من الدول تجاوزت هذه المسألة عبر اﻹشارة في دساتيرها على أحقية كل المكونات القومية والعرقية في البلاد بالتحدث والتعامل بلغتها، من دون إقصائها من المجال العام للدولة والوطن.
العامل الثاني هو الدين، الذي طالما كان تاريخياً علامة مهمة على هوية الأمة، وخاصة في المجتمعات التي لم تكتمل فيها عملية الحداثة وفق المفهوم الغربي، أي فصل الدين عن المجال العام وتحويله إلى شأن خاص، ما تسبب في شروخ متعددة للهويات الوطنية، فالقول إن بلداً مثل سوريا، بلد علماني ـ بمعنى فصل الدين عن الدولة ـ هو مجانبة للصواب، خاصة أنّ العلمانية بالطريقة التي طبقت فيها في سوريا أساءت للطرفين، الدولة والمجتمع، بل وربما للدين نفسه.
العامل الثالث هو الأرض، أو ما يسمى حديثاً حدود الدولة، التي تجمع السكان ذوي الانتماء الدولتي الواحد. إذ تعتبر الدولة الإقليمية العنصر الحاسم لوجود الأمة في العصر الحديث، وهو ما خلق المفاهيم اللاحقة لهذا المفهوم، أي السيادة وجواز السفر والمتحف والعلم الوطني.
وفي حالتنا السورية، فإنّ السلطات المسيطرة على الجغرافيات الثلاثة، تكاد تحيل هذا المفهوم إلى تقسيم غير معلن للبلاد، مع ما يعنيه ذلك في شأن موضوعنا، أي الهوية الوطنية، من تأثير تراجعي ومدمّر لهذا البنيان.
البعد الرابع هو التنظيم الاجتماعي وهو وفقاً لـ رودولفو ستافنهاغن «مصطلح علمي اجتماعي تقني يشير إلى شبكة معقدة من المؤسسات والعلاقات الاجتماعية التي توفر تناسقاً لمجموعة عرقية تتجاوز الهوية الشخصية لأعضائها الفرديين، إلى الحد الذي يشارك فيه الأخير في التنظيم الاجتماعي لمجموعته الإثنية. يحدد التنظيم الاجتماعي حدود المجموعة، وهو الإطار الذي يتم من خلاله تمييز "نحن" و"هم" و"المطلعون" و"الغرباء"...».
ينطوي التنظيم الاجتماعي على مستويات وحالات متعددة، وبالتالي قد تختلف أهميته بوصفه علامة على الهوية العرقية أو الوطنية. في بعض الحالات تكون للمجموعات الإثنية أو الدينية مؤسسات، وعلاقات اجتماعية عديدة ومعقدة مترابطة ومتشابكة، وقد تهيمن / أو تحاول الهيمنة على علاقة كامل تلك المجموعة بالسلطة.
البعد اﻷخير هنا، والمتداخل مع الأبعاد السابقة هو البعد الثقافي. ويُعنى بـ الجوانب المادية للثقافة، أي المنتجات الثقافية، ونظم القيم، والرموز، والمعاني، والأعراف، والتقاليد، والعادات التي يتقاسمها أعضاء المجموعة، وتميز «المطلعين» عن «الغرباء».
بما أن معظم الهويات البشرية ذات طابع اجتماعي، فإن الرموز التي تنتجها الجماعة تتحول إلى أحد أنساق صناعة الهوية التراكمية لها على مدار أجيال، من هنا نفهم لماذا تستعيد بعض (وغالباً معظم) الجماعات رموزها في الحروب والأزمات، وفي الشقاقات السياسية والاجتماعية، إذ، وأيضاً وفق ستافنهاغن «تشير تلك الرموز إلى الجماعة وأنصارها بوضوح، وترى أنهم يعملون كمجموعة نفسية واحدة عندما يكون هناك تهديد أو إمكانية تعزيز رموز الهوية».
هل نحتاج عقداً جديداً؟
بصورة أو بأخرى، يمكن تكثيف مفهوم العقد الاجتماعي في عبارة تعريفية مقتضبة: «تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم»، والحاكم هنا ليس بالضرورة فرداً، بل هو في الغالب الأعم منظومة قد تكون ديمقراطية كما لا نعرف في بلادنا، وقد تُختصر في فرد، فإذا غاب انتقل الاختصار إلى من يليه!
في كثير من البقاع خارج العالم العربي، لا يمكن أن نرى من يقبل الخضوع للسلطة مقابل اللاشيء: لا حقوق سياسية ولا اجتماعية ولا حريات عامة ولا شخصية. في المقابل هناك سلطة مطلقة للحاكم وأجهزته «تقود» المواطن حيث تريد
تعلو فكرة العقد الاجتماعي في أوقات الحروب، واﻷزمات الاجتماعية الكبرى، وتظهر هذه الحاجة بالدرجة اﻷولى في المجتمعات التي تغيب فيها الحريات، وتتسبب سياسات الحكم في التضييق على البشر، والحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كان العقد الاجتماعي السوري حتى العام 2011، مبنياً على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة مجانيين، مع محاولة استيعاب أكبر قدر ممكن منهم في مؤسسات الدولة. ومقابل هذه «المنافع» يتعيّن على المجتمع الخضوع إلى السلطة وأجهزتها، والابتعاد عن الحياة السياسية وعدم الخوض فيها.
تغير الحال جذرياً - لكن بالتدريج - في السنوات العشر الأخيرة، لنرى البلاد اليوم وقد سادت فيها عقود اجتماعية متعددة، ومختلفة من جغرافيا إلى أخرى تبعاً للطرف المسيطر، بل إن بعض الجغرافيات اختبر أكثر من عقد، وخاصة تلك الجغرافيات التي هيمن عليها تنظيم «داعش»، ثم زالت سيطرته.
اليوم، يمكن تمييز أربعة عقود أساسية في أربع مناطق سيطرة، فمنطقة شمال شرق سوريا تخضع لعقد اجتماعي مبني على مشاركة محدودة أو رمزية للمواطنين في الحكم، ومشاركة في المنافع الاقتصادية التي تقدمها الإدارة الذاتية. فيما يمكن تمييز عقدين متمايزين في مناطق سيطرة المعارضة، أولهما في إدلب التي تهيمن عليها «هيئة تحرير الشام» وحكومة الإنقاذ المحسوبة عليها، وثانيهما في مناطق شمال وشرق حلب، التي يسود فيها عقد مرتبط بتركيا مع هيمنة الأخيرة على المنطقة التي تديرها الحكومة المؤقتة.
العقد الرابع بطبيعة الحال هو السائد في مناطق سيطرة دمشق، الأكبر جغرافياً ومن حيث عدد السكان، وهو عقد نلاحظ بيسر أنه مختلف تماماً عما كان سائداً قبل الحرب، برغم أن السلطة هي نفسها.
من الضروري أيضاً الإشارة إلى وجود «عقود هجينة» في بعض مناطق سيطرة دمشق، بفعل اختلاف طبيعة السيطرة على الجغرافيا بين منطقة وأخرى، والمثال الأوضح هنا مناطق الجنوب. (ينطبق هذا جزئياً على بعض مناطق الإدارة الذاتية خاصة في موضوع تعدد الزوجات، الذي تمنعه في مناطق، وتبيحه في مناطق أخرى من جغرافيتها).
خاتمة ما لا يُختم
الآن، وأمام هذه المشهدية التي تحاول اختصار ما لا يمكن اختصاره، أترك الإجابة للقارئ/ـة عن سؤال مركزي وحساس وشديد الأهمية في مستقبل هذه البلاد، ومستقبلنا: هل تحتاج سوريا إلى عقد اجتماعي جديد؟ وإذا كانت إجابتك: نعم، تحتاج، فما السبيل إليه برأيك؟
وسأسمح لنفسي أن أختم بتقديم إجابة تمثلني، تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ:
الحاجة إلى عقد اجتماعي سوري جديد تقتضي حل سلسلة من المشكلات المتتابعة التي يحتاج حلها إلى اتفاق عام وجامع، قد تكون بدايته مؤتمرات ولقاءات وحوارات حقيقية وجادة في مختلف الجغرافيات، مع عمل جدي ومخلص للوصول إلى هدف واضح ومحدد: صوغ هوية وطنية، وعقد اجتماعي جامع.
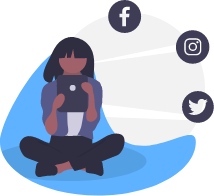
لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

