نورسين أمندا
الصورة: (Giuseppe Simeon - فليكر)
«غداً يمكن أن تأتي لمقابلة الطبيب» تقول رسالة وصلتني من منسقة مواعيد الطبيب النفسي في دمشق.
كانت هذه الزيارة أحد أهم أسباب قدومي في إجازة من البلد الأوروبي الذي أتابع الدراسة فيه، بعدما ألح علي في الشهور الماضية اكتئاب مزمن لم أستطع التخلص منه، ولم تناسبني فكرة الذهاب إلى طبيب نفسي هناك بسبب حاجز اللغة الذي رأيت أنه سيجعل الاسترخاء عند طبيب نفسي مهمة شديدة الصعوبة.
في اليوم التالي سأنام طوال الطريق، ولن أصحو إلا عند وصول الحاجز الرئيس على أبواب دمشق.
«تفضلوا الكل لتحت يا شباب، في أوامر جديدة بتفتيش الأغراض»، يقول مرافق السائق. ظننتُ الأمر مرتبطاً بإجراءات أمنية، قبل أن أسمع المسافرين الآخرين يستغربون، إذ تبين أن هدف التفتيش البحث عن علب التبغ!
الجميع يتحدث عمن يطلقون عليه اسم «ملك الدخان»، وعن منع جلب علبة سجائر واحدة من خارج العاصمة إلى داخلها بسبب ارتفاع الأسعار في العاصمة عن باقي المحافظات، مع احتمال القبض على كل من تسول له نفسه ارتكاب الخطأ الجسيم!
القانون في خدمة الشعب أليس كذلك؟
نمضي بعد انتهاء تنفيذ الأوامر الجديدة نحو مدخل دمشق، حيث الأبنية المهدمة كما كانت قبل سنوات.
تستقبلك العاصمة بالدمار المنتشر على جانبي الطريق، باستثناء بضع مبان جديدة ترتفع بخجل هنا وهناك، ولا تنجح بتمويه شيء من الخراب الممتد على مرمى النظر.
أستقل «السرفيس» بسرعة، أجلس كالعادة «بالعكس»، وأحاول تفحص وجوه الركاب الثلاثة، قبل أن تبدأ الجموع بالتكدس في الداخل.
أحاول النظر في كل الاتجاهات، كي لا أغفل أي مشهد من مشاهد العاصمة التي لم تربطني بها علاقة جيدة حتى في سنوات السلم. كنت أبحث عن تلك المشاعر التي يتحدث عنها كثرٌ فلا أجدها، وألوم نفسي على عدم تعلقي بالأمكنة.
يقطع شرودي توقف الحافلة بين الحين والآخر، لكي يصعد وافد جديد يزيد من تلاصقنا، وتلاحمنا الوطني.
أصل «جسر الرئيس»، لأنتظر طويلاً وطويلاً كما يفعل أهل هذا البلد منذ سنوات عديدة، بلا جدوى. أضطر أخيراً إلى ركوب «تاكسي» تشغل وظيفة «سيرفيس» وهذا صار حلاً بديلاً لمعظم الناس، بدلاً من دفع أجرة التاكسي كاملة من قبل شخص واحد.
أحسب مجموع ما دفعته في سبيل محاولتي التخلص من الاكتئاب، فإذا بي أصاب باكتئاب آخر.
نعتبر أنفسنا محور العالم ونقطة ارتكازه، بينما نسيَنا العالم، وأصبحنا مجرد خبر عادي في نهاية نشرات الأخبار بعد أن تصدرناها سنوات. حتى «الامتياز» الوحيد الذي منحتنا إياه الحرب لم يعد في متناول اليد!
تعبر السيارة أحد الأحياء «الراقية». تمكن بسهولة ملاحظة الفارق بين المشهدين، بين العاصمة وبقية المدن من جهة، وبين حي وآخر في العاصمة ذاتها: نظافة الشوارع، أنواع السيارات، وجوه الناس وألبستها، طبيعة المحال وواجهاتها. كل شيء يصرخ بصخب عن الفروق الهائلة بين شرائح المجتمع السوري اليوم، بعدما كانت الطبقة الوسطى موضع فخر السلطة منذ عقود، والحجة الأبرز التي دأب البعث على إلقائها في وجه الآخرين عند كل حديث عن إنجازاته، قبل أن تنسحق هذه الطبقة من دون أن تشعر السلطة بأي حرج، أو تفكر حتى في تغيير شعارات الفخر. الفارق الجوهري أنها صارت تسمي كل شيء «إنجازاً»، حتى لو كان 4 ساعات تغذية كهربائية في اليوم لمعظم المحافظات، فيما ينعم سكان العاصمة بـ 8 ساعات، وببحبوحة ليليلة زائدة في تكرار لسياسات قديمة طالما فضلت المركز على الأطراف، والمدن على الأرياف، وطبقة كبار التجار وأصحاب الثروات على الفقراء وباقي أفراد الشعب.
أصل العيادة وأنتظر دوري. يخرج أحد أصدقائي «الفايسبوكيين» من غرفة الطبيب، أفكر أن أناديه باسمه ونتعارف على أرض الواقع، ثم أعدل عن الأمر.
أفرح في سري، فلست الوحيدة التي تجرأت على العادات وقصدت العيادة التي سأغادرها بعد ساعة ونصف الساعة لأجد في غرفة الانتظار خمس أو ست نسوة ينتظرن أدوارهن.
«أخشى أن مجيئك في هذه الظروف بحد ذاته قد يكون سبباً للاكتئاب» يبادرني الطبيب، أهز رأسي موافقة وألعن تفسي مجدداً..
ينتهي اللقاء أسرع من المتوقع، وأذهب لتناول الغداء مع بعض الأصدقاء، لتطالعني التناقضات الصارخة من جديد: المطعم ممتلئ بالزبائن، والطاولات عامرة بالأطباق.
أعود من العاصمة. يمضي الأسبوع الاخير من الإجازة الميمونة. أجتمع بمعظم أصدقائي، أزور مكان عملي السابق، أتعرض للسؤال الأصعب الذي أهرب منه منذ سنتين: ماذا بعد انتهاء الدراسة؟ ما هي الخطة؟ أهز رأسي حائرة فأنا لم أحسم قراري بالعودة إلى البلاد، أو المضي قدماً بعيداً عنها.
أتلقى وابلاً من التوبيخ على غبائي، الجميع يحسدني على الفرصة التي أتمتع بها للهرب من هذه الأرض، الكل يسألني المساعدة كي يسلك طريقاً آمناً، مهما بلغت التكلفة المادية.
«لا شيء ستحصلين عليه هنا سوى رسالة السكر والرز»، يقول صديقي ملخصاً المستقبل القريب الذي ينتظرني في حال العودة.
الجميع يتحدث عمن يطلقون عليه اسم «ملك الدخان»، وعن منع جلب علبة سجائر واحدة من خارج العاصمة إلى داخلها بسبب ارتفاع الأسعار في العاصمة عن باقي المحافظات، مع احتمال القبض على كل من تسول له نفسه ارتكاب الخطأ الجسيم!
يحاول عقلي إقناع قلبي بشتى الأساليب بصواب قرار الاستقرار في الخارج، أكرر أمام الجميع مزايا الحياة وسهولتها هناك، لا لكي أتباهى، بل لأقنع هذا الصوت في داخلي الذي يمنعني من اتخاذ القرار.
أعتقد أنني مصابة بمرض «تدمير الذات». ربما معظمنا كذلك. نحب دور الضحية - أفراداً ومجتمعاً - نبكي على الأطلال، ونتغنى بما كنا عليه. نكيل الشتائم لكل المجتمعات والشعوب التي سبقتنا بأشواط، ونعتبر أنفسنا محور العالم ونقطة ارتكازه، بينما نسيَنا العالم بأكمله، وأصبحنا مجرد خبر عادي في نهاية نشرات الأخبار بعد أن تصدرناها سنوات.
حتى «الامتياز» الوحيد الذي منحتنا إياه الحرب لم يعد في متناول اليد!
أمشي في شوارع مدينتي التي أحببتها دائماَ، أبحث عن ذكريات جميلة تثير لدي المشاعر فلا أنجح. نحن نفقد قدراتنا على الإحساس بمعاني الجمال، ونستحيل تلقائياً إلى أجساد تتكوم فوق الطرقات، نفقد انتماءنا السابق تدريجياً، ونتخلص من أوهام كثيرة علقت في رؤوسنا بكل ما يحمله ذلك من قسوة، ومن عري داخلي يجعلنا فريسة سهلة للضياع.
الضياع الذي بات اليوم حاضراً في كل كلمة وعند كل موقف، يستبد بالوجوه ويقود الخطوات نحو لا شيء! ويجمع بين معظم السوريين والسوريات بعد أن فُرضت عليهم أنماط محددة للعيش تتمثل كلمة سرها في التكيف، والتعود، والتأقلم مع الأزمات المتكررة واليومية، أنماط الاستهلاك باتت مقيدة بسياسة الحبة الواحدة والحبتين، لتغيب ثقاقة الوفرة التي كانت تميز الأسر السورية. لم يعد بإمكان السوري أن يطعم ضيفاً، فالسلطة قررت محدودية الخبز، والمازوت، والسكر، والرز، والشاي، والكهرباء، والماء، والأنترنت، والتبغ، وكل شيء.. كل شيء، بدءاً بلقمة العيش، وانتهاء بالطموحات والأحلام.
أما الخوف فغير محدود، ومثله الفساد، وسلب الحقوق، بينما غاب الأمل من قلوب وعيون السوريين، ليبقى مجرد كلمات وشعارات تتصدر الأبنية والمؤسسات عبر صور عملاقة طباعتها من النوع الفاخر لتظهر جودة الألوان، فيما يغطي السواد معظم ما حولها.
وحدها عيون والدَيك تنظر إليك بحب، وتتمنى بقاءك هنا، بينما تجاهدين كي تتجنبي النظر إلى تلك العيون، علك تنجحين في قتل مشاعرك، وتغليب عقلك للنجاة من كل هذا.
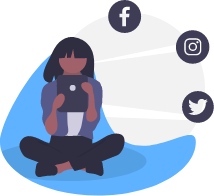
لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

