شغف
الصورة: (بودابست 2015 / x-andra photography - فليكر)
«آنسة.. حلوة سوريا؟ ابعتيلنا صور».
بحماس شديد يطرح الطفل ذو السبع سنوات المقيم في أوروبا هذا السؤال على مُعلمة اللغة العربية الموجودة في سوريا خلال درس عبر الإنترنت.
لم يكن هذا الطفل وحده من بين العشرين طالباً من يتملكه الفضول تجاه بلده الأم. وبرغم تفاوت أعمار الأطفال بين أربعة، وعشرة أعوام فقد توافقت رغباتهم: من لم يرها سابقاً يرغب في معرفتها، ومن تركها منذ سنوات يسأل عمّا آلت إليه.
المعلومة الواضحة في أذهان الجميع أن الكهرباء تنقطع باستمرار، فقد أشارت المعلمة إلى ذلك منذ أول درس، واعتاد الأطفال كلما اختفت المعلمة فجأة أثناء درس أن يرددوا الجملة ذاتها: «يي انقطعت الكهربا عندها».
اللغة الأم
يظل تعليم اللغة العربية للأطفال من بين أشد الهواجس التي تشغل بال أسر سورية كثيرة تعيش في أوروبا. وبرغم إمكانية تعلمها في بعض الدول من خلال بعض المساجد، لا تفضّل أسر كثيرة هذا الخيار لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالمناهج، واختصاصات المعلمين، وجنسياتهم، ومنها ما يرتبط بالخشية من تجيير الدروس لتكريس اعتقادات دينية متشددة.
أخيراً، صار الأمر سهلاً بعد انتشار الدروس عبر الإنترنت، وصار مألوفاً أن تتلقى مجموعة من الأطفال دروساً في اللغة العربية عبر الإنترنت من معلمة تقيم في سوريا لقاء مبلغ مالي شهري محدد، فضلاً عن افتتاح صفوف في بعض المداس لتعليم العربية في العطلات.
بات «طبيعياً» أن يعرف كثر من الأطفال الأصغر سناً دولاً أوروبية عديدة، فيما تغيب سوريا عن خريطتهم الواقعية وحتى الذهنية. أما الأطفال الأكبر فيعي كثير منهم وجودها، من دون وجود صلات وروابط حقيقية معها
تتفاوت معرفة الأطفال السوريين في الخارج باللغة العربية، فهناك من يتحدثها لكنه لا يجيد القراءة والكتابة إذ فقد البعض هذه المهارة لندرة ممارستها، والبعض كان أصغر من أن يتعلمها قبل مغادرة سوريا. وبعض الأطفال يتحدث العربية من دون إجادة تامة فتتخلل مفردات اللغة الثانية الكثير من كلامه، إما لأنه غير مُلم بجميع مفردات العربية، أو لعدم وجود مرادف لها في لغته الأم. وثمة شريحة من الأطفال تفهم العربية جيداً من دون استخدامها في التحدث لأن قدرة هذه الشريحة على التعبير باللغة الثانية هي الأسهل.
تقول إحدى الأمهات العازبات:
«أنا لحالي بألمانيا، وبشتغل. ابني طلع من سوريا عمره سنتين، بيرجع من المدرسة الساعة ستة، مضطرة خليه هالوقت الطويل بسبب شغلي، وما في رفقات أو معارف من عمره بيحكو عربي».
وتضيف: «أول فترة كان يفهم علي بس ما يعرف يحكي، بعدين ما عاد فهم شي، وفقدت التواصل معه، فصرنا نحكي بس ألماني».
فيما يقول أحمد (11 عاماً وهو الطفل الأكبر بين إخوته) باللغة الهولندية: «بحب العربي بس ما عاد عرفت أحكيه، لأنو بس أمي وأبي بيحكوا هي اللغة. أنا وإخوتي منحكي هولندي، وكل رفقاتي هولنديين».
في هولندا على وجه الخصوص تنصح جميع المدارس العائلات بالحفاظ على اللغة الأصلية في المنزل، لأن إتقان الأطفال للغة الثانية سيكون سهلاً مع الوقت بفضل المدرسة والمجتمع، إضافة إلى أن معرفة أكبر عدد من مفردات اللغة الأولى يُسهل معرفة المعاني من اللغة الثانية.
بضع صور وروابط
لا تزال بعض الذكريات الدافئة، واللقاءات العائلية، ولحظات الفرح عالقة في ذاكرة كثير من السوريين والسوريات خارج البلاد رغم سنوات الموت والحرب.
لكن الأمر لا ينطبق على الأطفال، فما تحمله ذاكرة من ولد منهم في سوريا يرتبط في معظمه بالموت والدمار، مع بعض الصور الجميلة الغائمة لدى البعض، بحسب عمر الطفل/ـة ومنطقة سكنه/ـا السابقة. فضلاً عن صور معاصرة أخرى تتشكل أثناء إجراء مكالمات فيديو عبر الإنترنت مع العائلة والمعارف في سوريا، وحتى هذه راحت وتيرتها تنخفض بمرور الوقت، ومع انخفاض معدل التحدث بلغة مشتركة، لتتحول بعض اللقاءات الافتراضية إلى تواصل بارد وصامت، يزيد من سمك الجليد الذي فرضته المسافات.
أبناء «الجيل الثاني» من السوريين والسوريات في أوروبا أكثر عرضة لاضطراب الهوية، وفيما قد يُعرف شاب عن نفسه بأنه «سوري يحمل الجنسية الألمانية» مثلاً، قد نسمع ابنته تقول إنها «ألمانية من أصول سورية»
تقول ليان (8 سنوات) التي تتحدث العربية بطلاقة إنها لا تتذكر شيئاً من سوريا سوى جدتها التي تكاد لا تتوقف عن ذكرها رغم غيابها عنها منذ خمس سنوات، وهذا يسبب لها حالات من الحزن والبكاء خاصة عندما ترى الأطفال في محيطها بصحبة الأجداد والجدات.
لا تقتصر المعاناة على قلة وجود أقارب ومعارف من الجنسية السورية فقط، فحتى الصداقات بين الأطفال من الجنسية ذاتها قليلة، وخلق الصلات صعب، بسبب ضيق الوقت، وضغوط الحياة، وبعد المسافات. في أحد دروس العربية عبر الإنترنت، استغلت إحدى الأمهات انقطاع الكهرباء عند المعلمة لتسأل الأطفال عن مناطق سكنهم، لأنها تبحث عن أصدقاء لابنها، لتسارع بقية الأمهات إلى التأكيد على هذه الفكرة.
الجيل الثاني و«القطيعة»
يشير هذا المصطلح إلى أبناء المهاجرين الذين ولدوا في البلد المضيف إلا أن آباءهم لم يولدوا فيه، وهم الأكثر عرضة لاضطراب الهوية بين ثقافة وعادات محصورة في المنزل، وبين حياة كاملة مختلفة في المدرسة والحي والمناسبات والأغنيات، وسائر التفاصيل اليومية. وفيما قد يُعرف شاب عن نفسه بأنه «سوري يحمل الجنسية الألمانية» مثلاً، قد نسمع ابنته تقول إنها «ألمانية من أصول سورية».
تقول بشرى (اسم مستعار) عن ذلك: «وُلد ابني بهولندا من 3 سنين. بيحكي عربي منيح، وهولندي، مع ذلك مرة قال لي: ما بدي أحكي عربي، حاكيني هولندي متلنا». وتضيف: «استوقفتني هذه الجملة طويلاً، ولم يكن سهلاً أن أشرح له، لأنه لا يعرف سوريا أصلاً، ولن يستوعب الفكرة في عمره هذا».
تقول ليان (8 سنوات) إنها لا تتذكر شيئاً من سوريا سوى جدتها التي تكاد لا تتوقف عن ذكرها رغم غيابها عنها منذ خمس سنوات، وهذا يسبب لها حالات من الحزن والبكاء خاصة عندما ترى الأطفال في محيطها بصحبة الأجداد والجدات
وبات «طبيعياً» أن يعرف كثير من الأطفال الأصغر سناً دولاً أوروبية عديدة بسبب سهولة الذهاب إليها في العطل، فيما تغيب سوريا عن خريطته الذهنية. أما الأطفال الأكبر فيعي كثير منهم وجودها، من دون وجود صلات وروابط حقيقية معها. بطبيعة الحال يختلف الأمر ما بين أسرة وأخرى بحسب طبيعة تعامل الأسرة مع الموضوع والانتباه إليه في مرحلة مبكرة، أو عكس ذلك، إذ تقرر بعض الأسر إبعاد الأطفال عن أي حديث مرتبط بالوضع في سوريا، فيما تكتفي أسر أخرى بالقول إن البلاد تمر بمرحلة صعبة من دون الخوض في التفاصيل لصعوبة وتعقيد ذلك، لكن المفاجآت تظل واردة بمجرد حديث مع الأقارب في سوريا.
تقول سمر (اسم مستعار) إنها تؤجل مشاهدة الأخبار إلى حين نوم أبنائها، حرصاً منها على عدم إيذائهم بمشاهد عنف، أو أخرى تثير تساؤلاتهم، رغم أنها لا تريدهم أن يعتقدوا أن الحياة وردية، فقد أبلغتهم بطرق عديدة أن ما يعيشونه في السويد هو أحد أشكال الحياة، لكنه ليس الوحيد. وتروي أحد المواقف قائلة: «مرة كنا أنا وبنتي عم نحكي مع أختي اللي بسوريا ورجع إبنها من المدرسة عم يبكي لأن الآنسة ضاربتو، انصدمت بنتي وقالت: بس هاد ممنوع، كيف بتعمل هيك؟ لازم يروح ع البوليس».
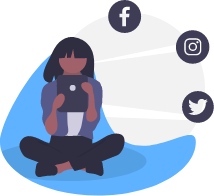
لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

