صوت سوري
الصورة: (John Phillips - فليكر)
في نقاش مع أحد الأصدقاء، كنت أحاول تقديم مقاربة لآليات نشوء الثنائيات المتضادّة في البلاد، وضعف جذورها. اعتمدت على معرفته بحوران (جبلاً وسهلاً)، وطرحت مثال درعا والسويداء، بوصفها ثنائية تستحق التفكير.
لكن، ما لم أكن أتوقعه، أن يكون رد فعل الصديق غاضباً كما فعل، راح يصرخ ويتهمني بالجهل، ويقول: «السويداء ودرعا لا تشكلان ثنائية متضادة، ولا يوجد في التاريخ ما يقول هذا».
تفهمت حينها أن حساسيةً ما، تجعل الرجل يكره هذا المثال، فحاولت أن أوحي بأن همي هو فقط فكرة الثنائيات المتضادة، وأنني أناقش أفكاراً، قلت له «انس درعا والسويداء، فلنأخذ مثالاً آخر»، لكنه قاطعني محتدّاً، وقال «كيف أنسى؟ هذا موضوع حساس».
لن أطيل الحديث هنا، الاستشهاد انتهى. ومنذ ذلك الحين نتجت في رأسي ثنائية جديدة، هي «من يعتقد بوجود ثنائيات متضادة في سوريا، ومن يرفض هذا»! هذه الخلاصة دفعتني إلى التفكير في معنى الاعتراف، وحاجته، وأهمية تفكيك المشكلة، إن وُجدت.
ردد كثر أمامي فكرةً، مفادُها أن مجرد الخوض في نقاش هذه الثنائية «السويداء، درعا»، ينطوي على جانبي خطر: الأول هو تكريس وجود هذه الثنائية المتضادة، وثانيهما أن هذا قد يقودنا إلى تفاصيل تشبه «إيقاظ الفتنة».
في الواقع، هناك رد على كلٍّ من النقطتين، فالنقطة الأولى مكرّسة في أذهان البعض - شئنا أم أبينا - والحاجة إلى تفكيكها تفترض وجوب إثارتها، وإثارتها ستجعلنا نؤكد تلك الفكرة المؤلمة التي تقول، إن خطاب الكراهية تنتجه «النّخب» وتحصد نتائجه العامة!
أما النقطة الثانية، المتعلقة بـ«خطر التفاصيل» فأظنّ أن قائله يفترض ذلك، ويفترض بلا معرفة.
لماذا؟؟
لأن من يعرف جذور العلاقة لن يخيفه الخوض فيها، بل سيوقن تماماً أن الخوض فيها هو بداية الحل. في الواقع، أنا أرى أن عبارة «بداية الحل» ليست دقيقة، لأنها تفترض وجود مشكلة متجذرة، الأدق هنا أن نقول: بداية الفهم.
دخلت المحافظتان في التنميط والتعميم، ودفعتا ثمن تحالفهما التاريخي ضد المحتل الذي عرف أن مصلحته تقتضي تفكيك التحالف وتحويله إلى عداء، وهو أمر ربما وعاه المستبدّ لاحقاً
في تجربة لتفكيك ما نسميه «خطاب الكراهية» في الجنوب السوري، عدنا إلى مراجع عدة، (كتب، وأشخاص). في الحقيقة لم تتفق هذه المراجع على سبب محدد، بل ذكرت ظواهر ومواقف، قديمة وحديثة، أكثرها لفتاً للانتباه، وأقدمها، يعود إلى العام 1851. وقتذاك، كان السلطان العثماني، يريد فرض نزع السلاح والتجنيد، في السهل الحوراني، والجبل، وفي اللجاة، ودرعا، وعجلون.
أرسل العثمانيون وقتها ستة آلاف عسكري معهم مدافع، وثمانية آلاف رديف احتياطي. كانت النتيجة، أن تكتّل السهل والجبل، وعجلون، والقبائل البدوية، واللجاة، فهُزم الجيش العثماني في أرض سهلية، في إزرع.
إثر الهزيمة الموجعة، صار هدف السلطنة العثمانية، تفكيك العلاقة بين السهل، والجبل، والقبائل البدوية، لتبدأ بعدها ألاعيب إثارة النعرات، ولفت النظر إلى الاختلاف الطائفي.
تعزز ذلك بعد العام 1860، مع وصول عدد كبير من أبناء الطائفة الدرزية، واستقرارهم في الجبل (معظم الأراضي التي استقروا فيها، كانت جبلية قاحلة غير مسكونة)، ليتزايد التحريض من قبل عملاء العثمانيين، بأن الوافدين الجدد يشكلون خطراً على وجود سكان السهل وعشائره.
جوهريّاً، لم يُنتج سياق العلاقة بعد ذلك صدامات حقيقية، ولا اشتباكات ذات قيمة تذكر - برغم حصولها أحياناً - بل أنتجت حوران (سهلاً وجبلاً) سلة غذائية متكاملة، فالجبل يقدم الفواكه، والسهل يقدم الخضروات. وتشارك السكان العادات، بدءاً من تحويل القمح إلى برغل، مروراً بأكلتهم الشهيرة المنسف، وصولاً إلى الأغاني الفولكلورية، ورقصة الجوفية.
بالتالي، كوّنت المحافظتان ما يمكن القول عنه «التاريخ المشترك». وهذا، لا نعني فيه قطعاً انتزاع تاريخهما من كلية التاريخ السوري، إذ إن تأثيرهما في سوريا يعرفه القاصي والداني. ما نعنيه هنا أن الاختلاف الطائفي، انصهر في الواقع الجغرافي، والمصالح المشتركة، والعادات المتشابهة، في إطار هوية مشتركة اسمها حوران.
من أين جاءت الخلافات؟
يعرف التاريخ الحضري والبدوي، القديم والحديث، أن حدوث نزاعات بين الجيران أمر يتكرر. وبرغم تعقيد علاقات الجيرة فإنها بطبيعة الحال تنتج تقاطعاً أكثر في التفاصيل والعلاقات، وبالتالي احتكاكاَ أكثر، مما قد ينتج بذور خلافات جانبية.
في ما يخص حوران، فإن وجود جذر (نستطيع بكل تأكيد اعتباره وهمياً)، وهو القلاقل ما بعد العام 1851، جعل من كل صراع بين أفراد، أو مجموعات صغيرة من المحافظتين، يتحول إلى بلبلة وشأن عام! في هذا السياق دخلت المحافظتان في التنميط والتعميم، وبالتالي دفعتا ثمن تحالفهما التاريخي ضد المحتل، الذي عرف بعدها أن مصلحته تقتضي تفكيك هذا التحالف وتحويله إلى عداء، (وهو أمر ربما وعاه المستبدّ لاحقاً)، لأن تكتلهما سيشكل قوة شعبية حقيقية، في خاصرة جغرافيا تعيش في قلب الصراعات العالمية.
يعرف التاريخ الحضري والبدوي، القديم والحديث، أن حدوث نزاعات بين الجيران أمر يتكرر. وبرغم تعقيد علاقات الجيرة فإنها بطبيعة الحال تنتج تقاطعاً أكثر في التفاصيل والعلاقات، وبالتالي احتكاكاَ أكثر، ما قد ينتج بذور خلافات جانبية
بالتالي؛ فعلى السائل عن «الخلاف» أن يسأل أيضاً: من المستفيد منه؟
والسائل هنا؛ عليه أن يستذكر - على سبيل المثال - أن الثورة ضد المستعمر الفرنسي لم تكن لتتم لولا إحساس أبناء المحافظتين بأنهما متلازمتان، فكانت كلّ منهما تحتاج أن تدرك أن خاصرتها محمية. لذلك؛ يذكر التاريخ أن الشيخ محمد الحسن الحريري، ومحمد الحسنين، ذهبا إلى السويداء قبيل الثورة السورية الكبرى، حاملَين بلاغاً موقّعاً من شيوخ ومخاتير قرى: الحراك، والحريك، وعلما، وخربة غزالة. يرحب البلاغ بحضور قوات من الجبل، ويعلن الأهالي عن استعدادهم لتقديم كل الدعم، ما زاد الحميّة عند أهل الجبل، لتتحرك القوات مع البيارق التي وصلت إلى المليحة والحراك، واستُقبلت بالأهازيج والنخوات.
إن مثل هذا الموقف المتكرر عبر التاريخ، هو الجذر الحقيقي للعلاقة، حيث الجماعي والمجتمعي يعبر عن التكاتف، والفردي في حالات قليلة يؤدي إلى خلاف، ليستفيد صناع الفتن من الفردي ويدفعوه في سياق التعميم، محاولين جرّه إلى الاجتماعي.
ولما كان المكوّن العشائري والقبلي أساسياً في السهل والجبل، فإنّ «صانع الفتنة» يظن أن مهمته أسهل، وأن تحويل الفردي إلى قبلي، ومن ثم إلى طائفي، أمرٌ يسير.
على أنّ ما يمكن تأكيده، استناداً إلى تاريخ طويل بين أبناء الجغرافيا الواحدة، أن الخلاف هو الطارئ، والشاهد الأساسي هو استمرار الجيرة، فلو كان الخلاف سيد الموقف، لكنا رأينا حروباً لا تتوقف، ودماءً لا تجف.
إن أرضاً تقدس الكرامة والكَرَم، وتتعهد الضيف والجار، أرضاً أنجبت مقاومين وطنيين، صاروا أيقونات، تقول لنا، إن علينا أن نتفاخر بما نحب أن نكون، وأبناء حوران، يحبون أن يكونوا أبناء مصطفى الخليلي، وسلطان الأطرش، والكثيرين من طينتهما، وإن لعنوا في لحظة غضب، لعنوا صناع الفتن!
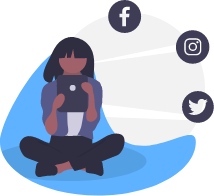
لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

